في مقال نُشر في أيلول/سبتمبر من عام 2020، اشتكى بيتر أندريه ألت، أستاذ الأدب الألماني في جامعة برلين الحرّة ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية (HRK)، من أنّ الثقافة المعاصرة تبدو كأنّها فقدت أيّ اهتمام بالتاريخ. ولاحظَ أنّ الكتب المدرسية تكيّف لغات الماضي الأدبية مع طريقة تعبيرنا الحالية، وأنّ البطلات الكلاسيكيات والأبطال الكلاسيكيين – “ميديا وهاملت، فاوست وكليوباترا” – يُعَصْرَنون في المسرح والسينما على حدّ سواء. ويختم بالقول: “إننا نعيش، اليوم، في عصر ما بعد التاريخ. نريد للماضي أن يشبهنا، فإن لم يكن كذلك، لم نُبْقِ منه على شيء. وهذا ما يصحّ بصورة خاصة على ’ثقافة الإلغاء‘ التي تريد أن تشطب شهادات الماضي من الذاكرة الجماعية إذا ما كانت تؤذي حساسياتنا الحالية”.[2] وإذ يرفض ألت مثل هذه المقاربات الحاضريّة، فإنّه يلحّ على تغاير الماضي: “على الفهم التاريخي، بادئ ذي بدء، أن يتناول الاختلافات التي تفصل حياة الماضي عن الحاضر”.
سوف تتّخذ مساهمتي في الجدال حول “مكانة الإنسانيات في القرن الحادي والعشرين” هذا القول المقتضب نقطةَ انطلاق لها. وأريد أن أستكشف، على وجه الخصوص، تلك الصلة المدهشة بعض الشيء بين نقد الحاضريّة (presentism)، من ناحية، ورفض ’ثقافة الإلغاء‘، من ناحية أخرى. وإذ أكتب من منظور باحثةٍ في الأدب والثقافة الإنكليزيين، مع اهتمام خاص بشكسبير والتاريخ الثقافي ودراسات الجندر والمثاقفة، فسوف أستكشف آثار قول آلت في الجدالات الحالية عن الإنسانيات وأقترح مقاربة بديلة تتخطى التضاد الثنائي الذي يقيمه بين الحاضريّة والتاريخيّة (historicism).
* * *
يشير ’الإلغاء‘ إلى سحب الدعم، لا سيّما في وسائل التواصل الاجتماعي، عن الذين تُعتبر أقوالهم أو أفعالهم العامة دفاعًا عن العنصرية أو الجنسانية أو رهاب المثلية، صراحةً أو ضمنًا.[3] ولقد امتد الجدال الساخن حول هذه الظاهرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا وألمانيا في العام أو العامين الماضيين. وتمثّل ’ثقافة الإلغاء‘، إذا ما كان لنا أن نصدّق منتقديها، تهديدًا كبيرًا لحرية التعبير والحرية الأكاديمية وتراثـ’ــنا‘ الأدبي والثقافي. وبالإضافة إلى التغطية الإعلامية الضخمة للحالات الفردية (كالسجال حول الترجمة الهولندية لقصيدة أماندا غورمان التي ألقتها في حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة[4])، ثمّة مبادرات وتدابير تستهدف على وجه التحديد مؤسسات التعليم العالي أو تنبثق عنها. وهذا يشمل، مثلًا، التعيين المدروس لمن يُدعون “أنصار حرية التعبير” في الجامعات البريطانية وتأسيس الشبكة الألمانية للحرية الأكاديمية. وكثيرًا ما تُستخدَم تهمة ’ثقافة الإلغاء‘ في هذه المناقشات كذريعة لتسويد صفحة النقّاد. ومن المسلّم به أنّه ليس كلّ اتهام تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي هو اتّهام مبرَّر، ولعلّ بعض حالات ’الإلغاء‘ الفردية كانت قاسية بلا داعٍ، في حين يستحق النقد الصريح أن يؤخذ في الحسبان في غالبية الحالات. وعادةً ما تكون التغييرات المجتمعية مصحوبةً بجدالات ثقافية محتدمة تعمل بدورها كمحفزات للتغيير، الأمر الذي تشكّل حركتا Black Lives Matter و#MeToo مثالين حيّين عليه. لكنّ عبارة ’ثقافة الإلغاء‘ هي حجّة شبيهة بمطرقة ثقيلة ترفض أيّ تدخل نقدي باعتباره أيديولوجيًا بحتًا، أي لا أساس له وغير عقلاني. وكما تقول إيف فيربانكس في مقال لصحيفة الواشنطن بوست: “مثل هذا التعبير يضع المتكلّم موضع الشخص العقلاني ويلقي على عاتق الطرف الآخر عبء التحوّط من أن يبدو هستيريًا. كما يحرف النقاش عن موضوعه الحقيقي ليغدو نزاعًا حول شكله: طريقة الشخص الآخر في تقديم شكواه”.[5]
يغدو الجدال شنيعًا عندما يكون الطلب إلغاء كاتب مُعْتَمَد ومكرَّس، مثل شكسبير. ففي منتصف شباط/فبراير 2021، نشرت أماندا ماكغريغور مقالًا في مجلة المكتبات المدرسية الأميركية بعنوان: “كيف ندرّس شكسبير؟ تلك هي المسألة”، تناقش فيه أهمية شكسبير بالنسبة إلى الطلاب المعاصرين وتشير إلى أنّ كثيرًا من المعلمين توصّلوا إلى “استنتاج مفاده أنّ الوقت قد حان لوضع شكسبير جانبًا أو التقليل من الإلحاح عليه لإفساح المجال أمام أصوات حديثة ومتنوعة وليست إقصائية”.[6] أثار نشر المقال احتجاجًا من وسائل الإعلام المحافظة: من بين آخرين، خشي لي براون على قناة فوكس نيوز من أنّ وليم شكسبير “سينبذه المعلّمون اليقظون [حيال قضايا المساواة العرقية والاجتماعية، (woke)] بسبب ’كراهية النساء والعنصرية‘”؛ وكشفت هارييت ألكساندر، في صحيفة الديلي ميل، “كيف ألغى معلّمو اللغة الإنكليزية ’اليقظون‘ شكسبير لما لديه من ’إيمان بتفوّق البيض وكراهية للنساء وعنصرية وطبقية‘؛ وراحوا بدلًا من ذلك يستخدمون مسرحياته لإلقاء محاضرات عن ’الذكورة السامّة والماركسية‘”.[7] والسؤال الآن، إذا ما ’أُلغي‘ شكسبير، فهل في ذلك انتهاك لحرية التعبير؟ هل أُسْكِتَ مثال التاريخ الأدبي الإنكليزي على نحوٍ مؤسف لتُستبدَل به روايات معاصرة من الدرجة الثانية؟ وهل هذا هو شطب ما بعد التاريخ لـ”شهادات الماضي” الذي اشتكى منها بيتر أندريه ألت؟ الحال، إنّ ماكغريغور لا تدعو إلى إزالة شكسبير من المناهج الدراسية، بل توصي بإدناء المؤلّفين الذين لم يُقرَأوا في العادة، بما في ذلك أدب السود والملونين ونصوص من الجنوب العالمي. وتستخدم التقارير المسعورة صفة ’اليقظة‘ واقترانها باللياقة السياسية اليسارية باعتبارها صرخة معركة سجالية ضد باحثين ومعلّمين يتحدّون مكانة شكسبير المُعْتَمَدة المكرَّسة، ويسلطون الضوء على انغماس مسرحياته في خطابات عنصرية أو بطريركية، ويستكشفون كيف استُعملَ ’الشاعر العظيم‘ كأداة في الاستعمار البريطاني. يبدو أنّ ردود الفعل الغاضبة مدفوعة بنفور من أيّ تغيير في الوضع القائم القديم وفي التوزيع التقليدي لرأس المال الثقافي. ثمّة اعتقاد أنّ القِدَم يضمن الجودة، لكنّ الأدب، للأسف، ليس نبيذًا أحمر.
ما دَخْل الإنسانيات بكلّ هذا؟ ليست الإنسانيات، في الحقيقة، ذلك المراقب البعيد بل جزء لا يتجزأ من هذه السجالات. ولدى اللغويين وباحثي الأدب والباحثين في التعليم والمؤرّخين الثقافيين – وبينهم سود وملونون – الكثير ليقولونه في شأن ما هو على المحكّ الآن: دور الثقافة الرفيعة والمُعْتمَد المكرَّس؛ شكل الذاكرة الثقافية والتراث الثقافي ومحتواهما؛ إرثُ تاريخٍ من انعدام المساواة الاجتماعية والعنف؛ السؤال عمّن يحقّ له الكلام وفي أيّ ميادين؛ قوة اللغة والأدب وكذلك قدرتهما على استجواب علاقات القوة الراسخة. وإذ تنخرط الإنسانيات في هذه الجدالات، فإنّها لا ’تنبذ‘ التاريخ مطلقًا بل تستكشف الطرائق التي يرتبط بها الماضي والحاضر على نحوٍ لا انفصام فيه.
قد تكون هنالك بالفعل بدائل للتضاد الذي أقامه بيتر أندريه ألت بين الحاضرية والتاريخية، وأودُّ أن أقترح “العبر تاريخية” (cross-historicism) كإحدى هذه المقاربات. وأنا أستعير هذا المصطلح من الباحث الشكسبيري بيتر إريكسون الذي يستخدمه ليتأمّل بصورة منهجية قراءته عطيل، مسرحية شكسبير التي تحكي عن جنرال أسود في جيش البندقية يقتل على نحو مأساوي زوجته ديدمونة، وهي من البندقية، إذ يحسب خطأ أنّها تخونه. في تحليله المسرحية، يقيم إريكسون حوارًا ديناميًا “يسمح للماضي بأن يشتبك مع ما هو معاصر ويتفاعل معه، ما يمكّننا من مواصلة العبور جيئةً وذهابًا بين هذين العالمين المتميزين”.[8] لا تنطلق مثل هذه القراءة من التماثل غير التاريخي الذي نجده لدى ما بعد التاريخ، لكنها لا تفترض أيضًا هوّة لا يمكن وصلها تفصل بين “هذين العالمين المتميزين”. وهذه المقاربة الأخيرة عرضة لأن تتغاضى سهوًا عن العنف العنصري في الماضي (أو عن كره النساء، إذا جاز القول) حين تلحّ على تغاير العقليات ما قبل الحديثة. ويدافع إريكسون، بدلًا من ذلك، عن منظور يهتمّ بالاختلافات والاستمراريات التاريخية. وهو يؤكّد أنّ هذا يصحّ خصوصًا حين نأتي إلى تحليل التاريخ المعقّد لـ’العرق‘، ذلك أنّ عطيل شكسبير “لا تحتوي داخل المسرحية ذاتها على إطار نقدي داخلي ملائم تمامًا للقضايا العرقية التي تطرحها. ويجب أن نأتي نحن بمثل هذا الإطار من الخارج”.[9] إنّ تركيزًا صريحًا على الوقت الحاضر – شحذته نظرية العرق النقدية ومعرفتنا الحالية بتاريخ العنصرية الأوروبية – يسمح لإريكسون باستخلاص السياقات/النصوص اللاشعورية لمسرحية شكسبير: منطقة البحر الأبيض المتوسط الحديثة الباكرة كمنطقة اتصال بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا؛ تجارة الرقيق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي؛ الحضور الأسود في أوروبا الحديثة الباكرة وإسكات الأصوات السوداء. لا يتحوّل شكسبير في مجرى ذلك إلى “معاصرنا” (يان كوت)،[10] لكنّ قراءة كهذه تحجم بالمثل عن وضع مفاهيم السواد الحديثة الباكرة على مسافة تاريخية آمنة يمكن أن ندرسها بانفصال فكري. وهي تلحّ، بدلًا من ذلك، على أهمية هذه القراءات بالنسبة إلى مجتمعات القرن الحادي والعشرين التي لم تصبح ’ما بعد عرقية‘ كما يعتقد بعضهم. إنّ “عبورًا” بين الماضي والحاضر جيئةً وذهابًا ليكشف عن علاقات تاريخية متناقضة، من دون افتراض أيّ استمرارية خطية أو غائية. وتُفهم اللحظتان الزمنيتان كلتاهما على أنّهما “تاريخان في حركة”[11] يؤثّر واحدهما في الآخر ويعدّله باستمرار.
يركّز إريكسون على ما يسميه “كلمات العرق” في عطيل (مثل، “شقراء” و”أسود” و”عبودية” و”ساحل بربري”) باعتبارها النقاط المحورية لمقاربته العبر تاريخية. لكنّه لا يرمي إلى تطهير النصّ من أيّ مفردات عنصرية قد “تؤذي حساسياتنا الحالية”. ومع ذلك، فهو يرى، مثل ماكغريغور، أنّ نوعًا من إبعاد شكسبير عن المركز ضروري لاكتساب الدراسات الأدبية قوة نقدية في الجدالات الأكاديمية والثقافية اليوم: “يبقى شكسبير جزءًا من الحوار، إنّما باعتباره صوتًا آخر، وليس باعتباره، تلقائيًا، السلطة النهائية أو المصدر الذي يُقصَد للاغتذاء الثقافي منه”.[12] وكما تُظْهِر سلسلة مؤتمرات وشبكات جديدة مثل RaceB4Race (جامعة ولاية أريزونا) أو مشروع مسرح الغلوب “شكسبير والعرق” (#ShakeRace)، فإنّ اللقاءات الفكرية والجمالية بين المرحلة الحديثة الباكرة ومرحلتنا المعاصرة يمكن أن تكون مثمرة للغاية وتعزّز التغيير، من دون أن تقصره على الأوساط الأكاديمية وحدها. وهذا ليس ’ثقافة إلغاء‘.
الترجمة عن الإنكليزية: ثائر ديب.


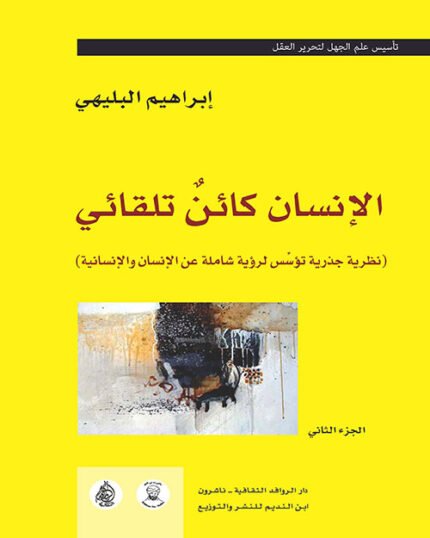


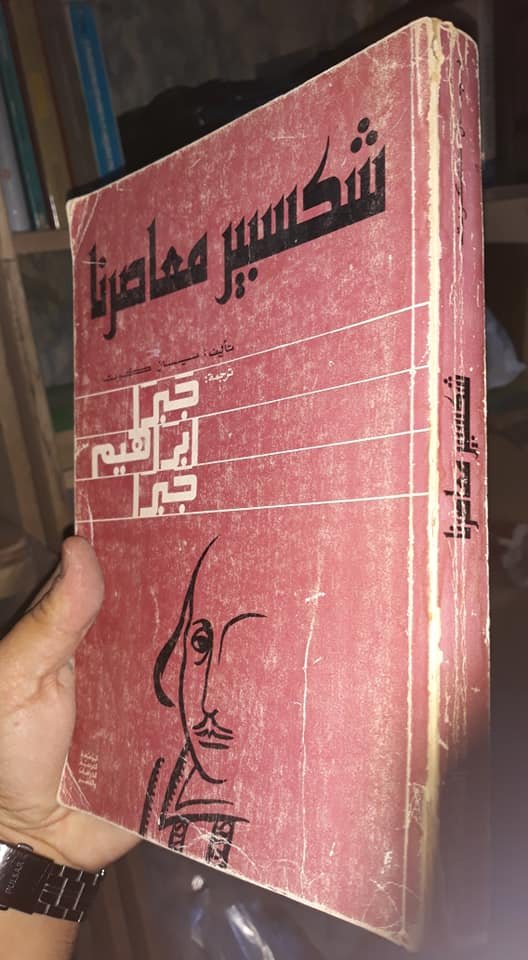














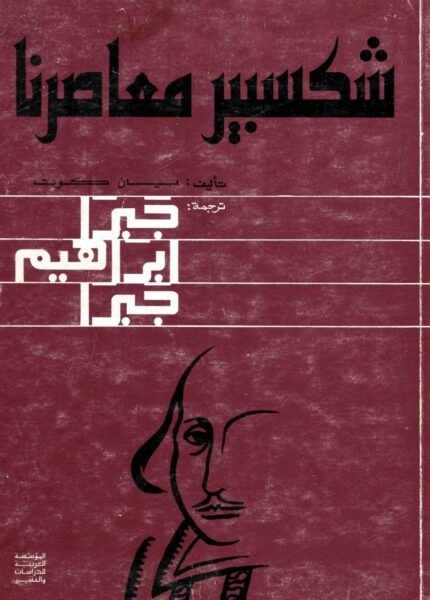
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.