«يا أهل النفاق…
تلك هي أرضكم. وذلك هو غرسكم. ما فعلت سوى أن طفت بها وعرضت على سبيل العينة بعض ما بها … فإن رأيتموه قبيحًا مشوهًا، فلا تلوموني بل لوموا أنفسكم … لوموا الأصل ولا تلوموا المرآه»
من خاتمة رواية (أرض النفاق)
الرواية الفانتازية رواية فلسفية أبدًا ودائمًا، وعالمها المتخيل مختبر لكل فكرة، وفي هذه الرواية يبحث المؤلف فيما يمكن أن يحدث لو كشفنا الغطاء عن كثير من الأفكار والمفاهيم التي شكلت المجتمع في زمانه.
هوت النكبة كصفعة ثقيلة على وجوه شباب المثقفين في زمنها فأيقظت بعضهم، وأذهلت بعضهم عن نفسه قبل أن تذهله عن العالم. وكان يوسف السباعي شابًا موهوبًا في الحكي، قدم نفسه للمجتمع الثقافي من خلال قصص داوم على نشرها في المجلات الثقافية منذ أن كان طالبًا في الكلية الحربية، وكان قد نشر أولى روايته عام 1947 بعنوان (نائب عزرائيل) وكانت فانتازيا فلسفية تعني بالموت والحياة، خاض فيها في منطقة شائكة، ولكنه حقق القبول من المجتمع الأدبي العربي؛ وفي العام 1949، وبعد مرور أقل من عام على النكبة، نشر على الناس روايته الثانية، موضوع اليوم، رواية (أرض النفاق)، فكانت رواية واقعية بحكم تناولها مسائل واقعية في زمنها، وفانتازيه ساخرة في الوقت نفسه.
بدأت الرواية مباشرة دون أي تمهيد، فالراوي – والذي يظل مجهول الاسم حتى نهاية الرواية – يعثر مصادفة في بقعة نائية عن القاهرة على متجر غامض لتجارة الأخلاق، يديره شخص يبدو كأنه يتأرجح ما بين الحكمة والجنون، يبيع أخلاق في صورة أعشاب، ويقرر الراوي أن يخوض المغامرة ويشتري مسحوق يمنحه الشجاعة لمدة عشرة أيام، ولكن الشجاعة تجلب عليه أصناف المصائب، وتدفعه إلى العديد من المعارك، قبل أن يذهب إلى مقر الجامعة العربية ليزيل عنها لافتة (الأمانة العامة) بأخرى تحمل عنوان (الخيانة العامة)، محملًا النخبة السياسية في العالم العربي مسئولية الهزيمة في فلسطين، ويقترح في موضع آخر الاستغناء عن الديموقراطية الشكلية والعاجزة بمسرحية منظمة تحفظ المظهر الديموقراطي وتوفر النفقات، وينتهي به الحال وقد عاد إلى محل الأخلاق يطلب شيء من الجبن لينهي مشاكله مع الشجاعة المتهورة، ولكن عوضًا عن ذلك يحصل على المروءة محل الشجاعة، ولكن مشاكل المروءة ليست أقل من مشاكل الشجاعة، فيصطحب كلبًا مشردًا إلى بيته يعقر أهل بيته جميعًا، ثم يلتقي بشحاذ يكشف له عن عالم التسول من خلال زيارة إلى مجمع الشحاذين، وهي الزيارة أقارنها بزيارة أخرى ذكرها القاضي التونخي في كتابه الفرج بعد الشدة لنقابة الشحاذين في بغداد، وعلى الرغم أن الشحاذ يحاول أن ينقذه من المروءة بلا فطنه، يستمر صاحبنا في الوقوع في المصائب، منتهيًا به الحال يمشي في شوارع المدينة مرتديًا قميص نوم حريمي وطربوش وقد ضيع مدخرات أسرته.
يلوذ الراوي بمحل الأخلاق وصاحبه من جديد، ليمنحه هذا مأوى حتى يتخلص من أثر المروءة المنفلتة، ولكن الراوي يسرق خلاصة الأخلاق من المحل ويقذف بها في النهر وهو يظن أن ذلك سوف يخلق مجتمع أخلاقي مثالي، ثم يقرر أن يذهب ليتجول في المدينة بصحبة تاجر الأخلاق ليستطلع ماذا أصاب الناس من تغيير جراء فعلته، فيذهبان إلى مجلس عزاء مدير الراوي الذي توفى، ليكتشفا كيف أن أخلاق بلا فطنة ولا شفقة كشفت سرائر حقود أنانية طالما اخفاها النفاق. وفي صلاة الجمعة، ينفجر الإمام منكرًا على نفسه وعلى المصلين حالة السطحية التي تجعلهم يؤدون شعائر الدين بالبدن دون الروح ودون أن تغير هذه الشعائر من حياتهم. لينتقلا إلى مؤتمر انتخابي، ليشهدا كيف يبيع المثقف/الخطيب روحه للمال السياسي في لحظة انقلاب هذا المثقف على نفسه بفعل روح الأخلاق، ليفضح نفسه ويفضح السياسة، ثم يفضح السياسي نفسه مقرًا على نفسه بالجهل والانتهازية والفساد وقبل كل ذلك بالاستوليد على عامة الشعب؛ وفي مركز المدينة تبلغ توابع روح الأخلاق التي سرت في الماء وشربها الناس ذروتها؛ حرس السجون يطلقون المجرمين الصغار لأن المجرمين الكبار من الزعماء السياسيين ورؤساء الأحزاب والكبراء مطلقي السراح، والشحاذون يلعنون الناس، والناس تعتدي بالضرب على وزير في حفلة تكريمه، والأزواج الغير سعداء يقتلون الحموات ويفرون من الزوجات.
انتهى الأمر بالقبض على الراوي وسيق للمحاكمة، التي تتحول إلى مناظرة بين مجتمع يخفي مساوئه بالنفاق أو يفضحها بالأخلاق، وبينما يقرر النظام أن يعلق الراوي على المشنقة جزاء جريمته نشر الأخلاق في المجتمع، يقتحم الناس دار المحكمة وينقذون الراوي مطالبين بأن يعيشوا في مجتمع أخلاقي، مطالبون تاجر الأخلاق بأن يمنحهم من أعشاب الأخلاق، ويخبرهم تاجر الأخلاق أن هذه الأخلاق في صدورهم تنتظر منهم أن يحرروها.
لم يهاجم السباعي القيم الأخلاقية للمجتمع، بقدر ما يهاجم النظام الاجتماعي نفسه ومؤسساته، فتراه يسخر من جلد الذات الذي يمارسه البعض بإلصاق كل نقيصة بقومه وكل مكرمة في الغربيين، ويسخر من البيروقراطية المشغولة باللوائح والقوانين والمراتب الوظيفية دون أن تحقق شيء للمواطن، ويسخر من تمثيلية ديموقراطية الحقبة الليبرالية، ومن الصحافة التي ادمنت ترويج الأكاذيب، والنظام التعليمي الذي يزيف المساواة في حق التعليم، والمشروعات الخيرية التمثيلية.
تبدو حياة مؤلف الرواية يوسف السباعي نفسها أقرب إلى رواية، نشأ في كنف والده الذي كان أديبًا ومترجمًا لم يحقق شهرة كبيرة، عانى في صباه من وفاة والده، والتحق بالكلية الحربية ليلتحق ضابطًا بالجيش، في الوقت نفسه الذي راح يتلمس طريقه لعالم الأدب ناشرًا بواكير قصصه في المجلات الأدبية في وقته، كانت أعماله الأولى مثل (نائب عزرائيل) و(أرض النفاق) و(أم رتيبة) صادمة ومبشرة بمبدع واعد، وإن كانت هذه الأعمال قد عانت من ضعف وركاكة لغوية ربما كان سببها سعي المؤلف لتبسيط لغته، ولكن هذا العيب ظل يلازم السباعي حتى آخر حياته؛ عقب 1952، منحازًا لحركة الضباط الأحرار قدم روايته (رد قلبي) عام 1954، ولكن الرجل كان قد تبدل، وتحول الأديب الناقد الثائر على نقائص مجتمعه، إلى مؤلف لقصص وروايات رومانسية للفتيات المراهقات، وإن كان البعض أضاف إليه لقب فارس الرومانسية بسبب هذه الأعمال. شغل السباعي العديد من المناصب الرسمية والإدارية في المؤسسات الثقافية المختلفة، حتى تولى منصب وزير الثقافة عام 1973، وكان في هذه المناصب موظف وسياسيًا وليس مثقف. ظل هاجس الموت يؤرق السباعي منذ أن فقد والده، وقد ظهر هذا الهاجس بالذات في واحدة من أفضل أعماله، وهي رواية (السقا مات) الصادرة عام 1952، وقد جاء موت السباعي مأسويًا وصادمًا، عندما أقدم إثنين من مجرمي عصابة أبي نضال على اغتياله أثناء حضوره مؤتمرًا في لارنكا في قبرص في فبراير 1978. نهاية يجب الإشارة إلى (أرض النفاق) بفكرتها الطريفة ألهمت صانعي الأعمال الدرامية، فتحولت إلى مسلسل إذاعي، ثم فيلم سينمائي، ولكنه تحولت في الإذاعة وعلى شاشة السينما إلى عمل هزلي سطحي مدجن، لا يحتوي أي مضمون نقدي، ولا يمت بصلة للرواية الأصلية سوى اجتماعهما في الاسم وبعض الملامح.
بقلم: وسام محمد عبده


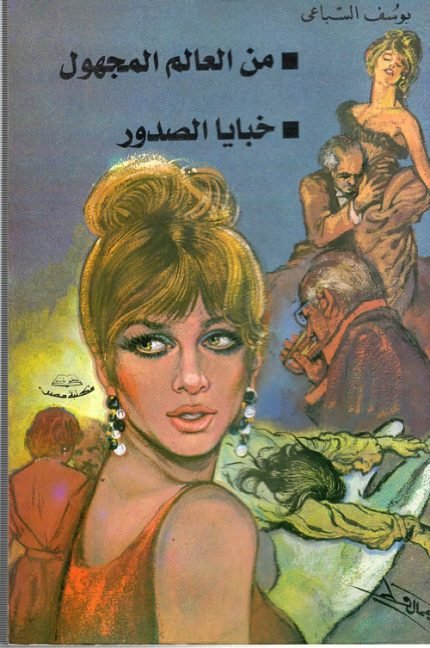









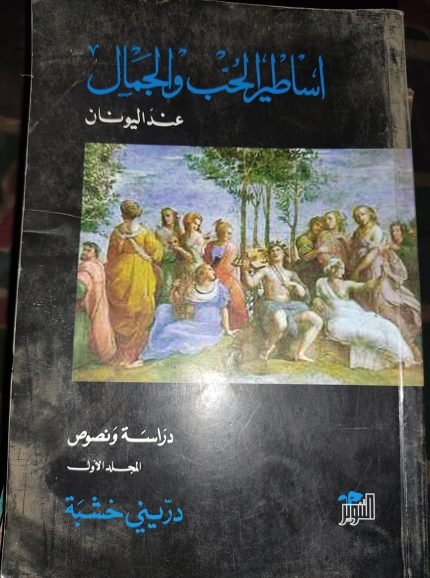
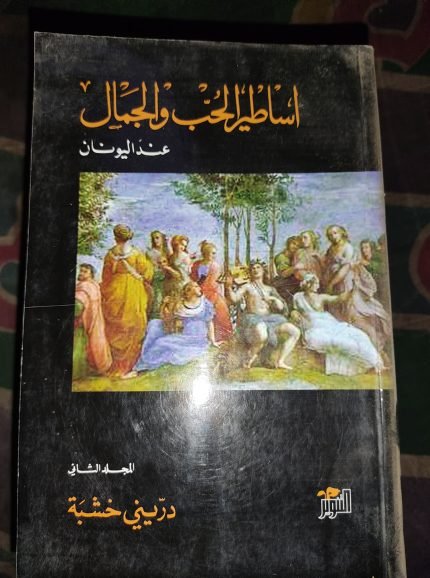

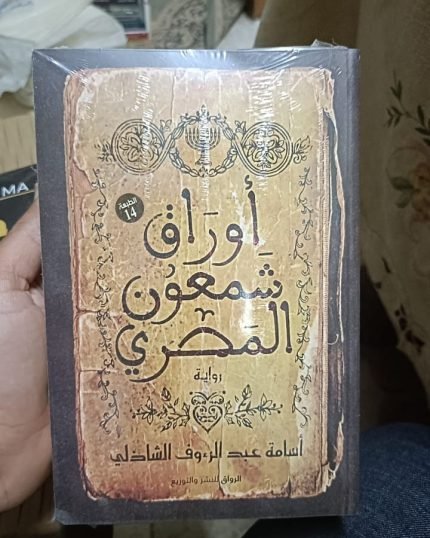





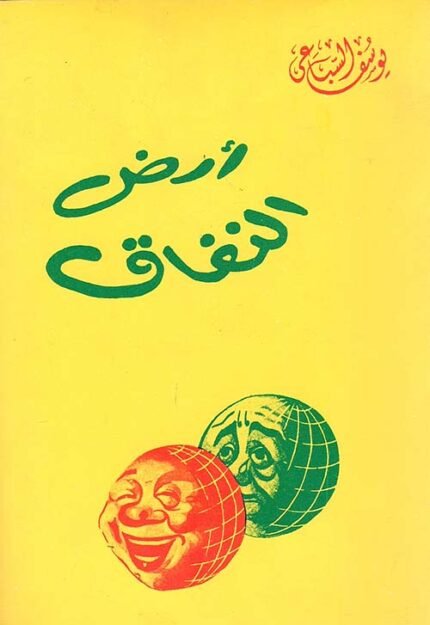
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.